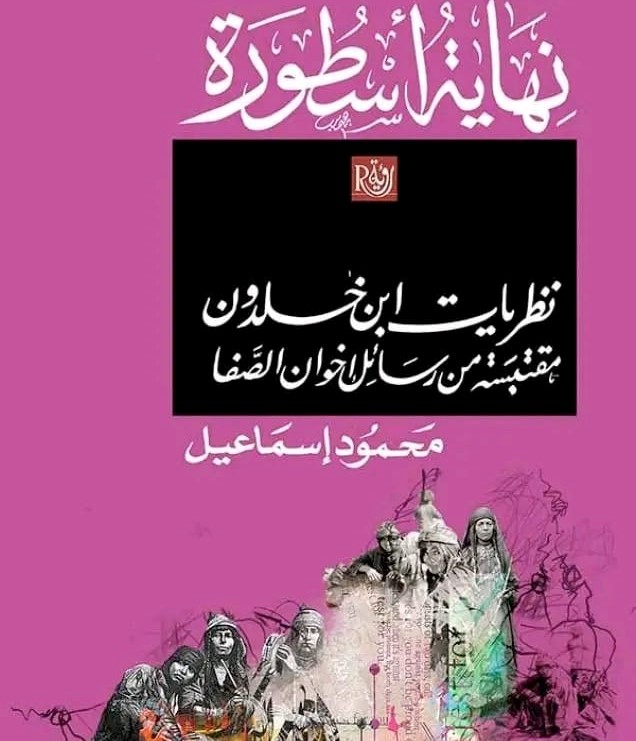
المؤرخ وعالم الاجتماع العربي ابن خلدون 1332
2024.05.29
محمد صفوح الأخرس
الموسوعة العربية
أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون (732-808هـ/1332-1406م)، وهو من أسرة عربية يمنية الأصل، تنحدر سلالتها من ملوك كندة، كانت تنزل حضرموت، فلما ظهر الإسلام واتسع الفتح بالغاً إسبانيا هاجرت إلى إشبيلية واستقرت فيها حتى قرب سقوطها في أيدي الإسبان، فجلت عنها إلى تونس حيث حلت وحيث ولد ونشأ ابن خلدون. وقد توفي أبواه وهو في السابعة عشرة من عمره، وكان به نزوع مبكر نحو العلم والسياسة، فدخل في خدمة أمير تونس ولم يتم العشرين، فتولى لديه «ديوان الرسائل» ثم انتقل إلى مراكش واتصل بسلطانها، ومنها إلى سلاطين المغرب وإسبانيا، وقد منحه نشاطه السياسي خبرة مميزة تأرجحت بين تحمل أعباء المسؤولية في درجاتها العليا؛ إذ عين وزيراً وحاجباً وقاضياً وفقيهاً، وبين حياة السجن والقهر والظلم.
وفي إطار العلم كتب ابن خلدون مجموعة من الرسائل إلى المعارف والأصدقاء أثبتها مع الإجابات عنها في كتابه «التعريف بابن خلدون»، وفي مرحلة الشباب ألف كلاً من «لباب المحصل» و«ملخصات في المنطق»، و«ملخصات في الحساب»، كما لخص مؤلفات ابن رشد كلها، وبعضاً من تأليف ابن عربي، وله «شفاء السائل في تهذيب المسائل»، وقد دخل التاريخ عبر مقدمته المشهورة في التاريخ وعلم العمران والتي يقول فيها أنه «أنشأ من التاريخ كتاباً، فصل فيه الأخبار باباً باباً، وسلك في ترتيبه وتبويبه مسلكاً جديداً».
مقدمة ابن خلدون
تتألف مقدمة ابن خلدون من «المقدمة» و«الكتاب الأول» المسمى بكتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»، والذي صدره بالعنوان الآتي: في طبيعة العمران في الخليقة، وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب، والكسب، والمعاش، والصنائع، والعلوم، ونحوها، وما لذلك من العلل والأسباب، ثم قسمه إلى ستة فصول رئيسة، الأول منه في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض، والثاني في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية، والثالث في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية، والرابع في العمران الحضري والبلدان والأمصار، والخامس في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه، والسادس في العلوم واكتسابها وتعلمها. كما قسم كل واحد منها إلى عدد من المقدمات والفصول.
ويفخر ابن خلدون بالتاريخ الذي ألفه؛ إذ يصرح أنه كان مبتكراً ومخترعاً لا مقلداً أو مقتبساً، ومع ذلك لا يدعي النجاح الكامل في تحقيق أغراضه، ولا يستبعد النقص والقصور في أبحاثه، بل يطلب انتقاده وإتمام ما بدأ به ممن يأتي بعده. يقول: «غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا، وكأن هذا علم مستقل بنفسه فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني، وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً، واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب النزعة، غزير الفائدة، أعثر عليه البحث وأدى إليه الغوص».
ويؤكد ابن خلدون أن موضوع العلم الذي أسسه «علم مستنبط النشأة»، وأنه كتب ما كتبه في هذا الصدد من غير أن يستند إلى قول أحد. فقد أدرك بوضوح وضع أسس علم جديد سيشهد توسعاً فيما بعد شأنه في ذلك شأن جميع العلوم التي تبدأ مختصرة ومجملة، ثم تتوسع وتتقدم بالتدريج، بسبب التحاق وانضمام المسائل الجديدة إليها شيئاً فشيئاً، وقد صح ما تنبأ به ابن خلدون في هذا المضمار، فالمسائل التي عالجها في مقدمته، غدت فيما بعد موضوع اهتمام المفكرين والعلماء، وتكون عنها علمان هامان، هما علم التاريخ وعلم الاجتماع.
طبائع العمران والاجتماع البشري
يتحدث ابن خلدون عن الطبيعة الاجتماعية للإنسان كونه كائناً اجتماعياً يستطيع بمفرده تحصيل ما يلزمه للبقاء على قيد الحياة من شراب وطعام وملبس، ومأوى، ومن دفاع عن النفس ضد الكائنات الأخرى الأكثر قوة أو شراسة، وهو لا يأمن هذه الشرور، أو يحصل على مثل تلك المنافع والحاجات إلا إذا تجمع، وتضافرت جهوده. ولكن الإنسان لا يخلو من ميل إلى العدوان، فإذا اجتمع الناس قدروا على تحصيل معاشهم وأمنوا العدوان الخارجي، ولكنهم والحال هذه يتعرضون لعدوان آخر أكثر ضراوة وإيذاء هو عدوان الإنسان على الإنسان ضمن الجماعة نفسها، ولذا فهم محتاجون إلى أن يقوم بينهم وازع ورادع تكون له القوة والغلبة والسلطة، ليتمكن من كف أذى بعض الناس عن بعضهم الآخر، والحد من تمادي أو تطاول جماعة على أخرى، أو فرد على غيره، إذن فالمعنى الأساسي لوجود الدولة هو حفظ كيان المجتمع وصيانة أمنه واستقراره، ليعيش الناس وينتجوا ويتكاثروا، وهذا هو جوهر معنى الدولة.
ومن هنا يؤكد ابن خلدون أن الاجتماع الإنساني ضروري للبشر ويؤدي إلى التعاون بين الناس، فإذا ما تعاونوا وتفرغت كل مجموعة منهم إلى عمل تقوم به، فإن ذلك يتطلب منهم تنظيماً اجتماعياً، يضبط علاقات الناس وتعاملهم مع بعضهم في أنساق اجتماعية متعددة وهذا ما يعرف بالعمران.
وتتسم الحياة الاجتماعية في المجتمعات المبسطة بأنها غير معقدة النسيج، لقلة عدد أفراد كل منها وقلة مطالبهم، واقتصارها على الضروريات، كما تتسم بشدة الضبط الاجتماعي، ومتانة العلاقات الاجتماعية، لقيامها أساساً على قاعدة وطيدة من العصبية، وهي روح المجموعة التي تنشأ عن القرابة. ويكون الفرق بين العمران البدوي أو الريفي والعمران الحضري، أعظم في الدرجة منه في النوع، وفي مدى تشابك الحياة الاجتماعية وتعقد نسيجها وفي مقدار التنظيم الاجتماعي أي العمران، ولما كان البدو أقدم من الحضر وسابقاً عليه، والبادية أصل العمران والأمصار مدد لها، فإن ابن خلدون قد ركز أفكاره أولاً حول العمران البدوي وأحوال الناس فيه، وأساس العلاقات الاجتماعية بينهم، وسماته الخلقية وكيفية تحولهم من البداوة إلى الحضارة.
ويقر ابن خلدون بأن البيئة بمعناها الشمولي هي السبب المباشر في اختلاف البشر جسمياً وعقلياً ونفسيا وخلقياً، وأنها هي التي تميز مجتمعاً ما عن غيره في تقاليده وعاداته ومنازعاته واقتصادياته وشؤونه المختلفة، غير أن هذه الحتمية التي درج عليها ابن خلدون لم تكن مطلقة، لأنه يرى أن التفاعل بين البيئة الطبيعية والإنسان لا يحدث من جانب واحد؛ إذ إن الإنسان يؤثر بدوره في البيئة نفسها كما تفعل فعلها فيه.
الدولة وبناء المجتمع
يرى ابن خلدون أن للمجتمع البشري شكلين اثنين يمر بهما في تطوره هما البداوة والتحضر، ويجدهما طبيعيين مع أنهما يختلفان في أوصاف أجيالهما، ولما كان ابن خلدون يربط بين العصبية والبداوة على نحو شبه متكامل، ويرى أنه على المجتمع أن يبني دولته ليدرأ خطر غيره، وكان المجتمع لديه شبيهاً بالكائن الحي، فقد جعل للدولة في تطور المجتمع ثلاثة أجيال، الأول منها لم يزل على خلق البداوة وخشونتها والبسالة والاشتراك في المجد، ولا تزال سورة العصبية قائمة فيه. ويتحول الجيل الثاني بالملك والترف والرفاهية من البداوة إلى الحضارة والخصب، وتتكسر شوكة العصبية لديه بعض الشيء إلا أنه يبقى له بعض الاعتزاز في سعيه إلى العصبية ومحاولة الدفاع عنها وحمايتها، أما الجيل الثالث فينسى عهد البداوة والخشونة، ويفقد حلاوة العز والعصبية، ويبلغ الترف غايته فيصبح عالة على الدولة، مما يدفع بصاحب الدولة إلى استكثار الموالي واصطناع من يرفع عن الدولة بعض العناء حتى تصاب الدولة بالهرم وتذهب بما حملت.
ويرى ابن خلدون أن القيادة تكون جماعية في مرحلة تأسيس الدولة، والجماعة كلها تسير وفق محور العصبية، ولكن ما أن تنتهي مرحلة الكفاح والتأسيس ويثبت وجود الدولة وينقلب زعيم الجماعة ذات العصبية إلى ملك حتى تشتد نزعة التملك والتفرد لديه، فيبدأ بإقصاء بعض أبناء عصبيته وأعوانه، وتنقضي المرحلة الأولى بعد استتباب شؤون الدولة، ويبدأ صراع بين الملك وأعوانه السابقين أو أقاربه وأبناء عشيرته. ومن هنا يصوغ ابن خلدون القانون الأول ومفاده «مبدأ التخلص من الأعوان الأصليين أو الميل نحو التفرد بالحكم» والأساس الذي يرتكز عليه القانون هو انتقال الدولة أو العشيرة إلى سكنى المدن وتركها شظف العيش وطلبها لطيب الطعام والشراب وزاهي الكساء وجميل العمران، والملوك في الغالب من السباقين إلى ذلك.
ثم نجد ابن خلدون يصوغ مبدأ آخر هو مبدأ الانتقال من البداوة إلى الحضارة، ومع أن ذلك نعيم من ناحية، إلا أنه جحيم من نواح أخرى لأنه يضعف الفهم، ويعوّد على الراحة، ويشجع الجشع في حب المال والانكباب على الشهوات، وتذهب معه عصبية الجماعة وحميتها، إذن فالمبدأ الثاني يحمل في طياته مبدأين آخرين، هما «الحاجة المتزايدة إلى المال» و«العزوف عن الشظف والميل إلى الترف» اللذان يترابطان أيما ترابط حتى كأنما يمثلان أمراً واحداً.
ثم إن الدولة تبدأ في العادة بسيطة، يتولى زعماء العشيرة الظافرة شؤونها على نحو مختلط من غير تقسيم العمل، ولكن ما أن تثبت الدولة على حالة الاستقرار نوعياً وتتسع أعمالها ونطاقها حتى تبدأ بإنشاء الأجهزة والدواوين المتخصصة والمتعددة، ويحتاج القائمون على الأمر إلى أصحاب الكفاءات لإدارة شؤون الحكم وهم قلما يعثرون على الأمين الكفء، فتجدهم لهذا يقنعون مجبرين بالصفة الثانية، إذ لا خير يرجى من أمين بليد، هذا ما يجر على الدولة وبالاً عظمياً، ويفعل فعله في تسريع هرمها، وهذا المبدأ يعبر عنه بقانون «الانتقال من البساطة إلى التعقيد في إدارة شؤون الدولة».
وتفعل جملة المبادئ السابقة فعلها في كيان الدولة فتضعف قوتها، وتنكسر شوكتها، ويقل مالها قياساً إلى حاجاتها، فتبدأ بإرهاق المواطنين بالضرائب والرسوم المجحفة، وقد تلجأ إلى مصادرة الأموال والأرزاق، مما يؤثر سلباً في بنية الدولة فيقل التفاعل الاجتماعي وتصير الحال إلى أشبه ما يسمى اليوم بالاقتصاد المغلق فتشيخ الدولة، وتشرف على الزوال، ومرجع ذلك كله في نظر ابن خلدون إلى العصبية وخمود نواتها في جسم الدولة وإذلال ما تبقى فيها من روح وحمية، ونتيجة لذلك يبدأ الاعتماد على المأجورين بدلاً من ذوي القرابة والعصبية فتقل التضحية، كما أن حياة التحضر والرفاه تذهب بشجاعة الإنسان واندفاعه في سبيل حفظ المبادئ الحقة أو الذود عنها، ويتكل فيما يتصل بشؤونه كلها على غيره مما يفضي إلى الجيل الهادم للدولة، وهو الجيل الرابع الذي ولد وربي في النعيم، وحسب أن مقاليد الأمور ستأتيه بلا مشقة، فينشغل بالملذات عن إدارة الدولة ورعاية مصالحها العامة، ويؤنس منه الوداعة والمسالمة اللتان تقودان شيئاً فشيئاً إلى الضعف والعجز، وهنا تؤذن الدول بالزوال، وفي بعض الأحيان يهيأ للدولة في آخر أطوارها ملك قوي متحمس فيه بقية من عنفوان العصبية يقوم بمحاولة إرجاع الدولة إلى طور شبابها ليجنبها الزوال، إلا أن فعله سوف لن يؤتي ثماراً لأن القوانين الاجتماعية التي يسير المجتمع والدولة وفقها (بوجه أقرب إلى الحتمية) لها فعلها، وهي أقوى من إرادة الأفراد، ثم إن العصبية هي التي تنتج المجتمع والدولة والفرد والقائد، وليس بإمكان الفرد القائد أن ينشئ دولة أو مجتمعاً بلا عصبية، وليس بإمكانه أن يعيد الحياة إلى البذور الميتة والعصبية المتحللة.
الاقتصاد والمجتمع
يرى ابن خلدون أن للحكومة أو الدولة تأثيراً بالغ الأهمية على بنية وشكل وجدوى الاقتصاد، فهو يربط الاقتصاد بالمجتمع عن طريق الدولة، لأن الدولة هي التي تتيح أفضل الفرص ليقبل مواطنوها على العمل وتطوير الإنتاج والصناعات، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الحياة الاقتصادية، لأن الدولة الحقة والعادلة تبغي وتعي رفعة شأنها وتحاول في سبيله ما أمكنها. وصعود الدولة مقترن طردياً بصعود الاقتصاد، لأن الدولة تأخذ بالارتقاء والنمو وتكتسب القوة حين تمتلك تسييراً اقتصادياً مزدهراً متطلعاً إلى التحسن والتوسع المستمرين. وتدخّل الدولة في معالجة وتسيير الاقتصاد في المجتمع يأخذ أحد شكلين، حسب نمط التدخل وهدفه وكيفيته، فالشكل الأول معني بالخير العام أو صالح الجماعة ككل، حينذاك تنشط الدولة في إنشاء المشروعات وشق الطرق والترع وما إليها وإقامة المنشآت العامة والأبنية، مما تعجز عنه الإمكانات الفردية للمواطنين كما تهيئ السبل للمواطنين ليعملوا ويتمكنوا من الحصول على مستوى لائق من العيش، وتلك الفعاليات التي تقوم بها الدولة تيسر للحياة الاقتصادية طريقاً وتزيد الحاجة إلى العمل والتفنن فيه، فيرتفع بذلك المستوى الاقتصادي العام لهذه الدولة.
أما الشكل الثاني فيصب اهتمامه على الخير الخاص أو صالح الفرد الحاكم أو الأسرة المالكة. وإذ ذاك يبتعد الحاكم عن رعاية أمور المواطنين وشؤونهم ومصالحهم ويستهدف ربحاً شخصياً فيتحول في نظر ابن خلدون إلى تاجر، وقد تتحول الدولة بمجموعها إلى تاجر منافس للتجار يفرض على الآخرين أن يبيعوه بالسعر الأدنى وأن يشتروا منه بالسعر الأعلى فيحذر الناس من الخوض في مجال التجارة والاقتصاد، ويتخلفون عن خوض ميادينها، وتقل عمليات البيع والشراء أي الحركة التجارية، فيبالغ الحاكم - نتيجة للحاجة المتزايدة إلى المال - بفرض الضرائب والغروم (الغرامات المالية)، ويرفع الأسعار فوق مستوى قدرة المستهلكين، فتقل قدرتهم الشرائية، ويتضاءل الطلب، فيقل الإنتاج. وهنا يولي ابن خلدون الاقتصاد مكانة بارزة في تكوين الدولة وفي تحديد عمرها، وحتى في تحديد الطور الذي هي عليه. فالاقتصاد لديه - على ما يبدو - يمثل العنصر الثاني من عناصر تكوين الدولة، أي أنه في المرتبة الثانية بعد العصبية.
ويربط ابن خلدون الاقتصاد بعدد السكان من جهة العمل البشري والنشاط الاجتماعي فيقول: «وأما الأمصار الصغيرة والقليلة السكان فأقواتهم قليلة لقلة العمل». فقد توصل إلى أن العمل هو جوهر الحياة الاقتصادية وقوامها، لأنه رأى أن كسب الرزق يقوم على عمل الإنسان وسعيه، أما دور الطبيعة فثانوي، ولا يمكن الاعتماد عليه لأن ما يوفره يكون في المقدار الضئيل ويتم مصادفة.
ومما يدل على أن العمل لدى ابن خلدون يعد قوام الحياة الاقتصادية، ما أكده في الباب الخامس من الكتاب الأول في المقدمة من أن ازدهار الاقتصاد إنما يكون نتيجة كثرة الأعمال، وأنه يضمر بتقهقرها لأنه يقيم الإنتاج وبقية ظواهر الحياة الاقتصادية على العمل الإنساني، وهو في ذلك قد سبق الاشتراكيين المحدثين الذين يعدون العمل عنصر الإنتاج الأساسي، كما أنه من السابقين إلى تقسيم العمل بين عضلي وذهني وترتيبه على مراحل، يقول: «واعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت بالهندام واجتماع الفَعَلَة وكثرة الأيدي عليها».
ويجعل ابن خلدون طرق وأساليب كسب الرزق في أنماط عدة، منها أسلوب الزراعة (الفلح) وفيه نجد العناية بالحيوان وبالنبات وبالأرض وغير ذلك، ومنها أيضاً أسلوب التجارة الذي يمثل إحضار البضائع وتهيئتها للبيع وبيعها، إضافة إلى أسلوب الصناعة، ومن طرق كسب الرزق أيضاً الصيد، والكسب المتأتي عن طريق جباية الأموال من الناس، ويرى أن الزراعة كأسلوب للمعيشة بدأت أولاً لأنها تحتاج في الغالب إلى جهود جماعية وتلتها الصناعة، وهذه تحتاج إلى تعاون القدرات النظرية والعملية، ثم التجارة وهذه تتطلب ميزة خاصة لتحصيل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، ويبحث في مصير ما ينتج عن طريق وسائل الكسب المختلفة، فيجد أنه إما أن ينفق في سبيل تحصيل المعاش والرفاهية، أو أن يتخذ على شكل مال (رأسمال) في سبيل الحصول على مكاسب جديدة. ويقترب ابن خلدون من مفهوم فضل القيمة حينما يشير إلى تفاوت الناس في كسب أرزاقهم، وأن بعضهم يكسب ذلك من عمله والآخر يكسبه من عمل غيره، ثم تجده يصف الفلاحة في درجات الأعمال ذات الكسب القليل وهي مقترنة بالفقر، وتليها الأعمال الكتابية والدينية، أما أصحاب الدخول المرتفعة فهم أصحاب السلطة والصنائع.
وينظر ابن خلدون إلى التجارة على أنها عملية الشراء بسعر رخيص، ومحاولة البيع بسعر أعلى، والفرق ما بين البيع وسعر الشراء آت من إحدى طريقتين، أولاهما: إبقاء التاجر البضاعة لديه حتى يشتد الطلب عليها ويرتفع سعرها، وتجده هنا يشير إلى مفهوم الاحتكار. والطريقة الثانية: هي نقلها إلى مكان آخر شديد الحاجة إليها، وفي كلتا الطريقتين يظهر فهم ابن خلدون لمسألة العرض والطلب. كما عرف تجارة الجملة ونصف الجملة أيضاً، حين تحدث عن الباعة الذين يشترون من التجار الكبار في أنهم قد يطمعون عليهم بالأسعار والأوزان، ثم نجده يتحدث عن أخلاق التجار والباعة ومن إليهم من العاملين في التجارة، ويرى أنها بوجه عام أدنى من أخلاق أهل الشرف والمروءة والعزة.
ثم يقسم ابن خلدون الصناعات أو الحرف بحسب أهميتها النابعة من خلال كونها ضرورية لبقاء النوع الإنساني وفي مقدمتها الزراعة والتجارة والحدادة والخياطة والبناء، أما شرف موضوعها فهو أنها تتناول الإنسان أو جانباً من جوانبه المعنوية كالطب والتوليد والكتابة والشعر والغناء، ثم يوضح الوظيفة الاجتماعية لكل من هذه الحرف والمهن، وكذلك سبب قيامها وتاريخ تطورها بتمحيص عقلي وبرؤية تحليلية، فهو مثلاً، يرفض الرأي بأن العمالقة هم من أشاد الأبنية الضخمة القديمة ويرى أن الذين بنوها هم أناس عاديون استعانوا بالعلوم الهندسية وأساليب معينة لرفع المواد الثقيلة والكتل الكبيرة.
ويرى ابن خلدون أن للنقد شكلين، نظري وعملي (واقعي)، فالنظري من النقد هو ما يحسب على الورق في المعاملات التجارية وحسابات الدواوين وغيرها، أما الواقعي من النقود فهو ما يضرب فعلاً ويأخذ الشكل المتداول، وهو يختلف من دولة إلى أخرى.
النهج العلمي في البحث الاجتماعي
يعد ابن خلدون رائداً من رواد تطبيق المنهج العلمي بصورته الاستقرائية، خاصة في ميادين العلوم الإنسانية، بل يعد من وجهة نظر علم الاجتماع المعاصر أحد الرواد القلائل الذين ألموا بالكثير من مظاهر الحياة الاجتماعية إلماماً تعدى فهم المسائل الاجتماعية إلى صياغة القوانين وانتهاج المنهج العلمي والبحث الاجتماعي، مما مكنه من الربط بين الفلسفة والاجتماع وأصول البحث العلمي، فكان بحق فيلسوفاً من فلاسفة التاريخ والاجتماع والمعرفة والعلم.
ويتميز منهج ابن خلدون في دراسة الظواهر الاجتماعية بخصائص ثلاث هي: الشمول، والموضوعية، والنظرة التكاملية؛ إذ نظر إلى الظاهرات الاجتماعية نظرة شاملة تظهر من خلال حديثه عن ضرورة الاجتماع البشري، ثم التفصيل في خواصه إذ يشمل جميع جوانب الموضوع تاريخياً وجغرافياً وبيئياً، فجاءت المقدمة في اتجاه الإحاطة بالموضوع فكرياً من جوانبه كلها، الأمر الذي يجعل من الكتاب دائرة معارف عامة.
أما الموضوعية فتتجلى في تعريفه لواقعات العمران البشري وللأحوال، وتبيانها بالأمثلة الواقعية، ولكنه لم ينس في واقعيته وموضوعيته الأسس النفسية، فقد تحدث في الفكر الإنساني، وفي أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر، وفي العقل التجريبي، وكيفية حدوثه، وأثبت أن عالم الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب، إذ يقول: «إنما الذي فضل به أهل المشرق عن أهل المغرب هو ما يحصل في النفس من آثار الحضارة من العقل المزيد .... فيظنه العامي تفاوتاً في الحقيقة الإنسانية».
ولا تحتاج النظرة التكاملية في المنهج الخلدوني إلى كثير من الإيضاح، لأنه كان يصرح في مواقع كثيرة بأن هناك ترابطاً بين الوقائع الاجتماعية على الجملة وبين كل واقعة مفردة. فهذه الترابطات التي ينادي بها ابن خلدون في مقدمته هي دليل يؤكد نظرته إلى المجتمع على أنه كائن حي مترابط ترابطاً عضوياً. ويؤكد ابن خلدون أهمية التأثير المتبادل والتغير أو الصيرورة، ويمكن الاستدلال على ذلك في تقييمه للمنطق، فقد رأى فيه علماً ومنهجاً للبحث، ومن هنا تميز تفكيره بالعلمانية والمنهجية في بحثه للظواهر الاجتماعية والاقتصادية، لذا فقد عالج الحياة البشرية والتفاعل الإنساني من منظور حركي، فلم يبحث في الأشياء الاجتماعية، وإنما في التفاعلات والتطورات التي تطرأ عليها، كما أطلق على التفاعلات اسم العوارض الذاتية، وعلى التطورات اسم الأحوال.
أما المشكلات «الدخيلة» فلا يعتقد بها لأنه يفرق بين ما يلحق «العمران من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه» من جهة وبين ما يكون «عرضاً لا يعتد به» من جهة أخرى، بمعنى آخر أن العوارض التي ليس بينها وبين بقية الوقائع الطبيعية ترابط وتكامل هي مشكلات مؤقتة لا ينظمها قانون ولا يمكن أن تدوم. وبديهي أن تكون العلاقات بين «العوارض الذاتية» للتربية والظواهر الاجتماعية الأخرى أوضح وأوثق من علاقة المشكلات الدخيلة العارضة بمجموع النظام الاجتماعي. بل إن ابن خلدون إذ يحتفظ لكل ظاهرة باستقلالها يحاول أن يؤيد القانون الذي يكشف عن طبيعة إحدى الظاهرتين ببيان انطباق ذلك القانون على الظاهرة الأخرى أيضاً.
ويقر ابن خلدون بأن البيئة الجغرافية والاجتماعية هي السبب المباشر في اختلاف البشر جسمياً وعقلياً ونفسياً وخلقياً، وأنها هي التي تميز مجتمعاً ما عن غيره في تقاليده وعاداته ومنازعاته واقتصادياته وشؤونه المختلفة. وقد انطلق في تفسيره الأولي للظواهر من وجهة الرؤية الحتمية، لكنها ليست حتمية صارمة، فقد كان واعياً أنه يتعامل في بحثه مع الإنسان، لذلك أفسح في المجال للإبداع الإنساني ولتأثير العقل والذكاء والعمل، وبين بوضوح أثر هذه العوامل الاجتماعية البحتة في تقدم الحضارات الإنسانية، وأدرك أن العلاقة بين البيئة والإنسان يحكمها قانون التأثير المتبادل، ويعلل ذلك تعليلاً يكاد يكون جدلياً يعتمد على تضارب العادات وتفاوتها وتركيب المتضارب المتفاوت منها، يقول: «النـاس على دين الملك، فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لا تزال المخالفة في العوائد والأحوال واقعة». وتحتل الأهداف النظرية للدراسة الاجتماعية عند ابن خلدون المكان الأول، ويكاد لا يأبه للأهداف العملية، ولذلك فإن بحث الأهداف عنده يقوم على أساسين، هما التمحيص وكشف القانون. فقد كان الغرض الأساس لابن خلدون أن يكتب كتاباً في التاريخ مدفوعاً بما اكتشفه من أغلاط المؤرخين من قبله. ولذلك بحث عن الوسيلة التي يستطيع بها تمحيص الأخبار ووجد أن ذلك لا يكون إلا بمعرفة «طبائع العمران» من جهة «والعوارض الذاتية التي تلحقه» من جهة أخرى.
كما أن من أهم الأسباب التي دعته إلى إنشاء هذا العلم الجديد حرصه على تخليص البحوث التاريخية من الأخبار الكاذبة، وعلى إنشاء أداة يستطيع بفضلها الباحثون والمؤلفون في علم التاريخ أن يميزوا بين ما يحتمل الصدق وما لا يكون كذلك في الأخبار المتعلقة بظواهر الاجتماع. مرجعا الأسباب الداعية للكذب إلى أمور ذاتية تتعلق بشخص المؤلف وميوله وأهوائه ومدى انقياده إليها، أو الجهل بالقوانين التي تخضع لها كل من الظواهر الطبيعية والاجتماعية، وإلى «الجهل بطبائع الأحوال في العمران، فإن كل حادث لابد له من طبيعة محضة في ذاته وفيما يعرض له من أحواله، فإذا كان السامع عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب». فقد أخذ على المؤرخين قبله أنهم اقتصروا على نقل الأخبار:«وأدوها إلينا كما سمعوها ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفعوها، فالتحقيق قليل وطرف التنقيح في الغالب كليل».
ويعد كشف القوانين في نظر ابن خلدون وسيلة ضرورية لتحقيق الهدف الأول «التمحيص»، فهو يعتقد أن «كل حادث من الحوادث، ذاتاً كان أو فعلاً لابد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله». وواضح انه يقصد بقوله طبيعة أو عوارض ذاتية ما يسمى اليوم «قانوناً».
وقد شبه العلاقة بين العلة والمعلول بالعلاقة بين المبتدأ والخبر: كل واحد منهما مرتبط بالآخر، وأشار إلى ذلك في عنوان كتابه، فقال: «ولما كان مشتملاً على أخبار العرب والبربر، من أهل المدر والوبر، والإلمام بمن عاصرهم من الدول الكبر، وأفصح بالذكر والعبر في مبتدأ الأحوال وما بعدها من الخبر، سميته كتاب العبر وديوان المبتدأ أو الخبر».
أما الوسائل، وهي إحدى خصائص الدراسة الاجتماعية لابن خلدون، فمنها ما يتعلق بالعقيدة والفلسفة، ومنها ما يتعلق بالتفكير العلمي والمنهج المنطقي، ومنها ما يتعلق بالصنعة والتطبيق الفني. أما ما يتعلق بالعقيدة فهي عقيدة التوحيد التي يؤمن بها ابن خلدون، إضافة إلى أنها كانت الطابع المميز للبيئة في عصره، ومن العقيدة ذاتها ينبع موقف فلسفي هو الإيمان بالحتمية، أي إن ظواهر الكون الواحد تخضع حتماً لقوانين موحدة لا تختلف باختلاف الزمان والمكان ما دام يسيطر على الكون إله واحد.
ويظهر ابن خلدون انطباق القانون البيئي على الظاهرة الاجتماعية من دون أن يلحق الدراسة الاجتماعية بالدراسات البيئية. ونتيجة لوحدة الظاهرة ووحدة القانون فإنه يوحد أنحاء البحث ويجمع المقارنة التاريخية مع المقارنة الجغرافية على أساس أن كلاً من النظريتين تتمم الأخرى.
وتتضح معالم التفكير العلمي عند ابن خلدون في بيان أسسه كالشك المنهجي، والإيمان بالعقل، والرجوع إلى الوقائع ثم بيان خصائصه كالموضوعية والتجزئة، والدقة، وأخيراً بيان خطواته المنطقية في تحصيل المعلومات وفي عرضها، وقد استطاع عن طريق الملاحظة والمشاهدة أن يفنّد أقوال كبار المؤرخين، ومن خلال الاعتماد على التجربة والملاحظة الحسية وسائل أساسية من وسائل البحث.
ويتبع ابن خلدون في بحثه عن الحقائق المنهج الاستقرائي الذي يستند إلى جمع المعلومات، ومقارنتها وتصنيفها لاستخلاص القانون منها. ويعتمد في تصنيفه على أسس متنوعة منها «البيئة» إذ يصنف الظاهرة تصنيفاً تطورياً يبين بدايتها ونشأتها وتطوراتها حتى الهرم ومنها «الوظيفة» إذ يبين مثلاً شرف الصنعة وحاجة الناس إليها وثمرتها. ولا شك أن اعتماده على التصنيف في العلوم الاجتماعية تصنيفاً تشريحياً ووظيفياً قد ساعده على تعليل الحوادث «بعللها الذاتية» بدلا من البحث عن أسبابها البعيدة، وذلك ما جعله يفخر بسبقه المؤرخين والباحثين الاجتماعيين لا من حيث اكتشاف الموضوع وحسب بل من حيث الاهتمام بالطريقة البرهانية العقلية. وهو يعتقد أن التصنيف والتعليل وسيلة للتنبؤ ومعرفة المستقبل، فضلاً عن أنه تمحيص للماضي وتحقيق لأخباره.
ابن خلدون وركائز المعرفة الاجتماعية
يستطيع الدارس لأعمال ابن خلدون أن يقف على عمق دراساته، والآفاق التي فتحها لعلماء الاجتماع المعاصرين من خلال مطابقة كتاباته مع المفاهيم المعاصرة في علم الاجتماع وميادينه المتعددة، فقد بحث في البيئة، والاقتصاد، والسياسة، والحضر، وطرق كسب الرزق، والتجارة والصناعة، والنقود والأسعار. ولعل من أهم ما كتب فيه ابن خلدون هو علم الاجتماع السياسي إذ درس أسباب قيام الدولة ونشوئها، وإعمارها وأطوارها ونهاياتها متأثراً في ذلك بالحياة السياسية الاجتماعية والفكرية التي سادت القرن الرابع عشر الميلادي، إذ شهدت الأمصار الإسلامية كوارث عدة، وازدادت حدة هجمات الأعداء عليها وتمزقت أوصالها بفعل المؤامرات والحروب، وبانتشار التفكير الخرافي وسيطرة الجمود الفكري.
ويلمس القارئ لأعمال ابن خلدون مدى إلمامه الواسع بجميع جوانب الثقافة في عصره. فإلى جانب تخصصه في الاجتماع والتاريخ نراه متمكناً من سائر أنواع العلوم والبحوث، إضافة إلى ما تتصف به مقدمته من غنى الألفاظ وعمقها ودقتها وابتكارها، بسبب ما فيها من فكر غنية وعميقة ودقيقة مبتكرة. وإن هذا الأسلوب الذي اتبعه في وضع آثاره أسلوب جديد يمتاز بالسهولة والوضوح والتخلص من قيود السجع ومحسـنات البديع التي كان النثر العربي مكبلاً بها في ذلك العهد. ويبدو أن «سعة الشمول» في جميع المعلومات قد جاءت لابن خلدون من ثقافته الواسعة ومن تنقلاته الشخصية وطوافه في الشرق والغرب.
وقد سبق ابن خلدون علماء الاجتماع جميعاً في وقوفه من الظواهر الاجتماعية موقف العالم الذي يبحث عن «الأجناس» و«الفصول» ويرد الحوادث الفردية إلى الأصول. وقد جاء في نقده لمن سبقه من المؤرخين الذين اكتفوا بنقل المعلومات كما وردت إليهم يجمعونها جمعاً من دون ترتيب أو تصنيف قوله: «فيجلبون الأخبار عن الدول، وحكايات الوقائع في العصور الأول، صوراً قد تجردت عن موادها، وصفاحاً انتقيت من أغمادها ومعارف تستنكر للجهل بطارفها وتلادها، إنما هي حوادث لم تعلم أصولها، وأنواع لم تعتبر أجناسها ولا تحققت فصولها. لا يعترضون لبدايتها، ولا يذكرون السبب الذي رفع من رايتها، وأظهر آيتها، ولا علة الوقوف عند غايتها، فيبقى الناظر متطلعاً بعد إلى افتقاد أحوال مبادئ الدول ومراتبها، مفتشاً عن أسباب تزاحمها وتعاقبها، باحثاً عن المقنع في تباينها أو تناسبها».







