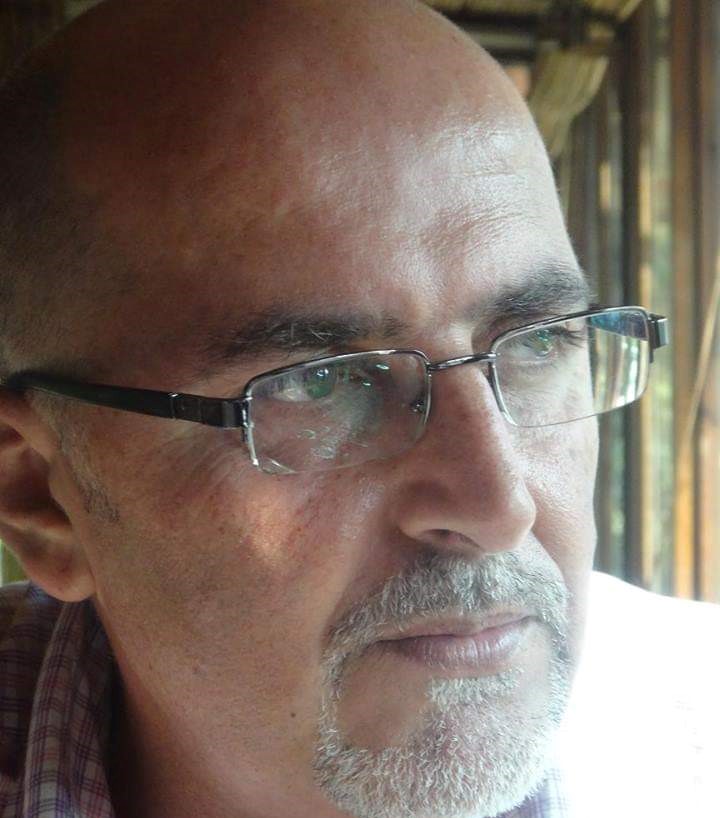
اعترافات متأخرة لمدخّن مزمن!
2024.08.22
محمد سعيد حسين- فينكس
كنتُ في الصّف الأوّل أو الثاني ..... أو السادس الابتدائي، عندما "نترني" أبي محاضرةً عن التّدخين ومضارّه، وضرورة الابتعاد عنه، ولم ينهِ محاضرتَه، إلا بعد أن "طيّر" نصف باكيت الحمراء الطويلة، نافثاً دخانها في رئتيّ، ما حرّضني على تجربة هذه الموبقة التي يصرّ والدي على "اتيانها" وإبعادي عنها بشتى السبل، وكم كانت دهشتي كبيرة عندما اكتشفتُ متعتها ليغلبَني الظنّ آنذاك، أنَّ أنانيةَ الوالد غلبتْ "حنانه" ويريد أن يستأثر بهذه النّعمة دوني!!
بعد فترةٍ وجيزةٍ من التدخين السري، نقل أحدُ "المحبّين" خبراً لأبي مفاده أنه شاهدني أضع سيكارة "أطول مني" بين شفتي، والمعزّة التي بيننا ـ يقول لأبي ـ جعلتْني أخبرك، كي تتصرّف قبل أن يأخذَها عادة "يقصدني طبعاً"..
وتصرّف أبي طبعاً........
كان في حديقة منزلنا في القرية، شجرةُ رمانٍ وارفةُ الظلال كثيفةُ الأغصان، وبعد قليل، أصبح في حديقة منزلنا في القرية، جذعٌ لشجرة رمان، كانت منذ قليل وارفة الأغصان، كثيفة الظلال!!
قبل أن تهدأ أوجاعي، وبينما كانت أمي تضمد ما استطاعت، من الجراح التي خلفتها قضبان الرمان على سائر جسدي، كنت أفكر كيف سأسرق باكيت أبي الحمراء، لأنتقم منه مرتين، مرة في الحزن الذي سيسبّبه له فقد الباكيت، ومرّة أخرى في القهر الذي سيعتريه عندما يعلم أنني دخّنتها كلّها في ساعةٍ واحدة..!! وثمة انتقامٌ آخر، لم أجرؤ حينذاك أن أعلنٕه لنفسي، وهو عزمي على تعليم أخوتي الأصغر مني ارتيادَ جنة التدخين الرائعة.!
كبرتُ قليلاً.. وقرّرتُ ـ عن قناعة ـ أنني فور انتهائي من تقديم امتحانات البكالوريا، سأقلع عن هذه العادة الرديئة التي لن تجلب لي سوى الخسارة المادية والصحية، وانتهت الامتحانات.. بيد أن قلق الانتظار ـ انتظار النتائج ـ جعلني أؤجل الفكرة قليلاً ، وبعد صدور النتائج، كان علي أن أدخّن بكثافةٍ، لأخفّف من الكرب الذي أصابني بسبب الرسوب..
وفي العام التالي، كان السبب الرئيسي لامتناعي عن "ترك" التدخين، هو العلامات الضئيلة التي نجحتُ بها، والتي لم تتح لي التسجيل في كلية الطب البشري، ولا في أي كلية أخرى، فازداد كربي، واشتدت مصيبتي، ولم يكن ليخفف عني هول أحزاني، سوى هذه السيكارة العجيبة!!!
وكانت الخدمة الإلزامية في الجيش، ملاذي الأخير، الذي سيخلّصَني "قسراً" من هذه العادة الرديئة، فراتب المجند لا يسمح له أن يأكل رغيفاً واحداً من الخبز في اليوم، فكيف بشراء الدخان؟!!
توكلت على "الفقر" وعقدت العزم على هذه النيّة، وأمضيتُ خدمتي الإلزامية، دون أن أدخّن سيكارة واحدة، سوى تلك التي كان يجودُ بها عليّ، الأجاويد من الزملاء، وكانوا كثراً، وعليه، قُدِّر لي أن أدخّن أكثرَ من أيّ مدخنٍ منهم، ولي في ذلك عذر، فهم الذين كانوا يتكرّمون عليّ، وليس من اللباقةِ والأدبِ في شيء، أن تردّ يدَ الكريم إذا مُدّت إليك بشيء، ولوّ.. نحن قوم نفهم بالأصول.!!
أنهيتُ خدمتي الإلزامية، وانطلقتُ إلى امتحانات البكالوريا من جديد، ولكن بفرعها الأدبي هذه المرّة، ومن الطبيعي ألّا أُشغلَ نفسي بمسألةٍ تافهةٍ كالإقلاع عن التدخين، وأمامي هذا التحدي العظيم، وبانتظار النتائج، كنت أدخن بشراهة لم تكن لتفلح في التخفيف من توتري، لو لم أبدل دخاني آنذاك، من (الحمراء الطويلة)، إلى (المارلبورو) ذي النكهة المميزة، التي قيل عنها أنها تتويجٌ لملذات الحياة، وهذا سببٌ آخر جعلني أبدّل إليها، إذ أتاحت لي هذه ، أن أتوج كل الملذّات التي لم أتعرّف على أيّ منها حتى الآن، بمتعةٍ ما بعدها متعة !!
صدَرَتْ النتائج، واستطعت الالتحاق بجيوش الدارسين في كلية الحقوق ـ جامعة دمشق ـ وهناك، كان من الطبيعي أن أؤجّل مشروعي إلى ما بعد التخرّج، حتى لا يؤثّر هذا على دراستي وجدّي واجتهادي!!
ما إن استقرّتْ بي الأحوالُ في الجامعة، حتى عادت الفكرة ـ فكرة الإقلاع عن التدخين ـ تراودني من جديد، لدرجةٍ أصبحتُ معها، أدخن عدداً مضاعفاً من السكائر في اليوم، وأنا أقلّب الأمر في ذهني، وأبحث عن الكيفية التي تتيح لي تنفيذ قراري بأقل الخسائر..!
انتبهت للأمر، وعقدت العزم على التنفيذ السريع، دون (إحم ولا دستور)، وفاجأتُ زملائي في السكن الجامعي ـ وكانوا ثلاثة ـ بهذا القرار، وكانت سعادتهم به لا توصف، "كونهم من غير المدخنين"، فقرروا التضحية بعشر ليرات من ثروتهم ثمناً لكيلو كرمنتينا، سفحوه على شرفي، احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة.. وبعد حوالي ساعتين من الاحتفال الكبير، كان علي أن أخرجَ من الغرفة، إلى أي مكان آخر لأدخن "آخر سيكارة في حياتي!!" دون أن يراني أحدٌ منهم ، فتبدأ مطالبتهم لي بالليرات العشر..
استطعت ـ بعد أيام ـ تدبر أمر الليرات، استدنتها من أحد الزملاء الميسورين، أعدتُ نصفها إليهم ودفعتُ الباقي ثمناً لباكيت الحمراء، بعد أن عقدت العزم على أنها ستكون الباكيت الأخيرة في حياتي..
تتالت الأيام.. وتتالت "الباكيتات" وكل واحدة بمفردها ، كانت "الأخيرة"، لأكتشفَ برعبٍ، بعد سنتين من الدراسة في كلية الحقوق، أنّ حجمَ ديوني، وعددَ دائنيّ، يتصاعد باطّراد، ولم يعد من الممكن تجاهل الأمر، لأتّخذَ ـ إثر ذلك الاكتشاف ـ قراراً قطعياً غير قابل لنقض أو نقاش، بـ "الإقلاع" عن متابعة الدراسة في كلية الحقوق..
لم يكن قراري الأخير سهلاً، ولم تستطع عشرات السجائر التي أصبحت أدخنها في اليوم، التخفيف من كربي وندمي الشديدين، إلى أن جاءني الفرج من غامض علم الله، بعد حوالي سنة من تاريخ تركي للدراسة.. حيث ابتُليتُ بنوبةٍ من الكريب الحاد، رافقَتْها نوباتٌ خانقةٌ ومتكررةٌ من السعال الشديد، أجبرتني على ملازمة المستشفى لعدة أيام كانت كافية لأن تجعلني أتشبث بالفرصة، وهكذا، استطعت، ولأول مرة في حياتي، أن أعي أنّه ثمّة إثبات حقيقي للمثل القائل "ربّ ضارّةٍ نافعة" حيث تابعتُ الحياة بعد خروجي من المستشفى بلا تدخين، وكان علي أن أتوّج احتفالي بهذه الخطوة الجبارة، بالعودة إلى الدراسة، وهناك.. في حي البرامكة بدمشق.. حيث تقبع بوداعةٍ وأمان، كلية الحقوق، كان كل شيء ـ حتى لبن العصفور ـ متوفراً وممكناً، ما عدا إمكانية عودتي للدراسة، والحجة ـ كما قيل لي ـ الفصل من الجامعة..
لم أكن قد استنفذتُ فرص الرسوب القانونية، حاولتُ الإيضاح.. معرفة الأسباب، و..لا آذان تصغي، و لا جواب!!
لأقتنعَ مع من قرروا واقتنعوا قبلي، أنه ثمة أسباب سياسية خلف هذا القرار، علماً أنني لم أكن أعرف من السياسة وعنها، سوى ما تقدمه لي "ولعموم الجماهير العربية" نشرة الأخبار والتعليق السياسي، وبقية البرامج "السياسية" عبر إذاعتي دمشق وصوت الشعب!!
أحد الخبثاء، ممن يعرفونني، ويعرف أنه ليس لي، في "عير السياسة ولا نفيرها" شيء، قال بلهجةٍ تخلط ما بين الجد والهزل والتهكّم، لا بد أنه تشابه أسماء.. أنصحك بمراجعة "الفرع!!"
وباعتبار أنني لم أكن أعرف عن أي فرع يتكلم، مع هذه الوفرة العظيمة بـ "الفروع" لدينا، آثرت أن أكتفي بمصيبتي، وألا أفتح على نفسي باباً لمصائب لا يمكن لكلّ من يراجع "الفرع" أن يتكهّن بحجمها وطبيعتها.. ارتضيتُ بنصيبي من "العلم" وكانت العودة إلى التدخين، متنفسي الوحيد، للتخفيف من هول الفاجعة!!
بعد زمنٍ لا أستطيع تقديره، عادت إلى ذهني فكرة الإقلاع عن التدخين، ولكن جميع محاولاتي باءت بالفشل لاصطدامها بعوائق لا تحصى، أهمها على الإطلاق، عدم امتلاكي الإرادة الكافية لاتخاذ قرارٍ "تاريخيّ" كهذا، والثّبات عليه، فقرّرت أن أعوّض هزيمتي أمام هذا "المرض الفتاك" الذي يسمونه التدخين، بمراقبة ولدي البكر، والعمل على نصحه وإرشاده، مبيناً له مضار التدخين والأمراض الفتاكة التي يمكن أن تورثها له هذه العادة الذميمة..!!! في محاضرة عظيمةٍ استهلكتُ خلالها أكثر من نصف كيس الدّخان البلدي، نافثاً دخانه اللئيم في رئتيه.
وكم كانت صدمتي عظيمة عندما اكتشفت أنّه يعيد لي "تاريخي المجيد" أمام ناظريّ، فعمدت إلى شجرة الرمان، وارفة الظلال، كثيفة الأغصان، التي في حديقة منزل جارنا في المدينة، لأجردها دفعةً واحدةً من ظلالها وأغصانها، وأهديها ـ بمنتهى الرفق ـ لجسد ولدي الذي لم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره بعد..!!







