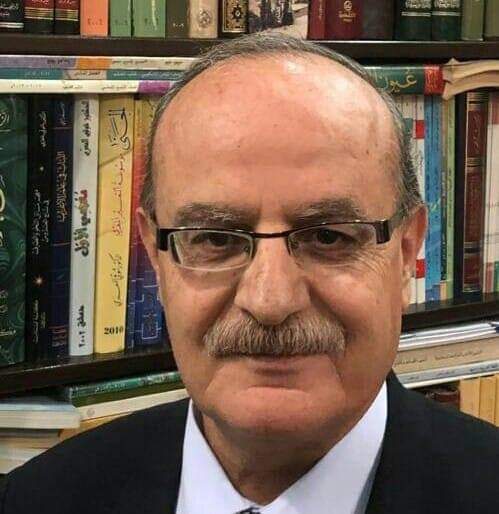
عِندَما يُوْدِعُ الصَّيفُ أيّامَهُ.. شَهرَ أيلول..
2024.09.02
د. شوقي المعري
١. الشام.. صيدنايا.. الشام..
رِحلةُ الأيام..
كانت أجمل الأيام التي نعيشها في ضيعتي "صيدنايا" تلك الأيام التي تؤْذِن بقدوم شهر أيلول، حيث تزداد النسمات برودة فتؤْذِن هي الأخرى بقدوم الخريف، وتبشر بقدوم موعد المدارس، وتبدأ عملية التحضير لوداع أيام الصيف الجميلة، والتحضير للرحلة نحو الشام الكلمة المحببة للجميع لما فيها من حنو وعطف، فتختلف عن دمشق العاصمة وضجيج الحياة فيها.
كان أول شيء نقرره هو أن نحجز الباص الصغير الذي كان سائقه صهر بيت عازر جريس (المعروني) نسبة إلى بلدته معرونة، إذ لم يكن "الميكرو" قد احتل شوارعنا بعد، ولم يكن آنذاك سيارات شاحنة صغيرة لنقل الأغراض والعفش التي كنا ننقلها في بداية الصيف من دمشق إلى الضيعة، ونعيدها أوائل الخريف إلى دمشق..
٢. في خزائنِ الصَّخر..
مَؤونتُنا..
قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى دمشق نضع المؤونة التي استغرق الناس، ولا سيما النسوة، صناعتها الصيف كله، لتسد حاجة العائلة الشتاء كله، وكانت هذه المؤونة مشتركة بين العائلات كلها، قوامها: اللبنة والجبنة والكشك والمكدوس والزيتون وربّ البندورة ومربى المشمش والتين والدبس.
وكانت قطرميزات الألبان والأجبان توضع في أماكن حفظها، وكانت مغارة قريبة من البيت، يضع فيها معظم الناس مؤونتهم، فهي تضاهي أجود أنواع البرادات، هذا غير الثلج الذي كان يساعدها في الشتاء، وكانت القطرميزات تعرف بأن تكتب كل عائلة الاسم الذي يميزه الآخرون على غطاء القطرميز. أما بقية المؤونة فكانت في البيت العتيق الذي كان صحياً يحافظ على المواد؛ لأن كمياتها كانت قليلة قياساً على المادتين الرئيسيتين اللبن والجبن.
٣. الأسطحةُ كما الطعام..
"ع مَد النظر"..
كانت العائلات تترك على الأسطحة أنواعاً أخرى من الطعام كانت تضاهي الفواكه المجففة، فيُترك الزبيب ليجف ويصبح جاهزاً لعملية صناعة الدبس، أما التين بنوعيه فكان يُمَد على أقمشة وبسط حتى يجفف، نوع يظل بكامل الحبة، كان يخزن في أوعية بعد أن يرش عليه الطحين كيلا تلتصق الحبات بعضها ببعض، ونوع شرائح تلتصق حباته بعضها ببعض ثم كانت تقطع وتطبخ ثم يرش عليها السمسم والجوز في حال وجوده. كما كان الناس يفرشون القمح المسلوق على البسط الواسعة وكان طعاماً مجانياً للعصافير تنقر منها ما يطيب في كل وقت دون أن يمنعها صاحب القمح، كما تُترك صواني البندورة المعصورة حتى تجف إلى غير ذلك من المؤونة.. أما باحات البيوت فكانت مكاناً للحطب الذي كان الناس يستعملونه للطبخ والتدفئة..
٤. نحن كنا نازلين..
من ضيعة صيدنايا
على ضيعة عين منين..
كان الزمن الذي تستغرقه السيارات بين الضيعة ودمشق نحو ثلاثة أرباع الساعة؛ إلا الباصات لأنها كانت تتوقف لنزول الركاب أو صعودهم، فسيارات ذاك الزمن من الطراز العتيق..
كان اجتياز منطقة سهل صيدنايا قبل الوصول إلى بلدة "عين منين" هو المكان الذي تترك فيه أقرب الذكريات، فإذا نظرت نحو اليمين فإنك ترى جبالاً عرفنا من دروس الجغرافية أن وراءها سلسلة جبال لبنان الشرقية.
وإن نظرت جهة اليسار فثمة هضاب قليلة الارتفاع تطل على بعض البلدات التي يتصل بعضها ببعض لتصل إلى دمشق.. وكانت أضواء دمشق بلا مبالغة تصلنا ليلاً..
ومثل كل من يودع حبيباً أو أهلاً ولما وصلت إلى آخر السهل الممتد التفتّ إلى الخلف أنظر من وراء زجاج الباص أودع ذكريات ثلاثة أشهر من السنة بل من العمر، قضيتها في تلك البلدة، على أمل اللقاء في العام القادم، وتبقى عيناي معلقتين.. حتى تغيب الضيعة عن النظر لكنها تبقى حاضرة في القلب ومعلقة بالعقل.
٥. بين جبران وغسان..
عشت دقائق..
أخذتِ السيارة تتهادى في تلك الطرقات المتعرجة على مهل، ولم أعد أرى إلا هضاباً وجبالاً وعلى الأرض حقول تظهر لي "جفنات العنب" وقد غفت على الأرض وعناقيد العنب "تدلت كثريات الذهب"، ورائحة أوراق شجر التين تعبق في المكان، وبعض العشب بدا يميل نحو الاصفرار نحو الخريف..نحو أواخر العمر..
كم تذكرت السيارة والسائق والطريق عندما درّست طلاب الصف الثامن قصة "حق لا يموت" للكاتب غسان كنفاني، ولا سيما تلك الطريق الصعبة في وسط عين منين، وأظن أن كبار السن مازالوا يتذكرونها..
تكمل السيارة الطريق تتجاوز التل، ثم حرنة، ثم معربا، وقبل برزة كانت ثلاثة أكواع شبه دائرية كان آخرها وهو أصغرها مكاناً لعدة حوادث..
لم يكن الناس قد بنوا "عش الورور" ولم تكن البلدية قد شقت الطرقات الحديثة.. ولا شارع فارس الخوري كان بهذا الشكل، وتستقبلنا ساحة العباسيين.. التي كانت أجمل من الآن على الرغم من كل عمليات التجميل التي خضعت لها..
كان الوصول إلى "كراج صيدنايا" يجبر الباصات أن تجتاز شارع حلب للوصول إلى ساحة برج الروس التي لا تزال إحدى حاراتها تحمل اسم "كراج صيدنايا القديم".
٦. ساحة وأوضة منسية..
مليانة غبار..
كان الباص الصغير يوصلنا إلى أقرب مكان من المنزل الذي كان في ساحة باب توما، بغبارها الذي كان يعلق منه على ثيابنا لما كانت ملعب كرة قدم لنا، كان بيتنا خلف البناء الحديث الوحيد الذي لا يزال حتى الآن وعلى يمينه حمام الشيخ رسلان.. فكان علينا حمل الأغراض إلى البيت، وبيتنا كان كبيت الضيعة غرفة وحيدة كنا نسكنها سبعة أشخاص..
لم تكن الأغراض التي نحملها من الضيعة كثيرة، والدليل أننا نحملها في سيارة صغيرة، فهي الضرورية للاستعمال الذي كان واحداً في الغرفتين، وواضح من الغرفة الوحيدة التي نسكنها وتسكننا.. أغراضنا هي بعض المؤونة التي نرفدها عندما تنفد، وبعض الثياب وبعض الأواني الضرورية التي كنا نستعملها في مطبخ الضيعة ثم في مطبخ دمشق المشترك مع الجيران..!
لذلك لم يكن ترتيب البيت يحتاج إلى وقت طويل ولا إلى من يساعدنا في تنظيف البيت، ولكننا نترك ما بقي إن بقي شيء من العمل الضروري، ونغفو من التعب على عبارة "الصباح رباح"..
٧. المسكية..
عِطرُ الكُتب أم مِسكُ العِطر؟
قلت في بداية الحديث: كانت العودة إلى دمشق قبل أيام قليلة من افتتاح المدارس.. وهذا يعني أن علينا إحضار كتب الصف الذي نجحنا إليه، وكانت حالنا كحال معظم الأسر التي تقتني لأولادها كتباً مستعملة، فإن لم يهبْك كتبَه قريبٌ أو صديقٌ أعلى منك صفاً، فأنت مضطر لشرائها من "المسكية" أو شرائها جديدة، وكانت المتعة في الطريق الذي سنسلكه نحو المسكية.
لم تكن المسافة طويلة بين بيتنا والمسكية، كنت أجتاز الطريق التي يحب كل الناس المرور بها، من الساحة قليلاً ثم إلى اليمين نحو حمام البكري واتجه على يساره بحارات ضيقة ليت بيوتها ظلت كما عرفتها، مروراً بالقيمرية، لم نكن نأكل الليمون المثلج من أشهر محلاتها، ولا الخبز المشروح من التنور الوحيد هناك إلا في طريق العودة، هذا إذا زاد معنا قروش من ثمن الكتب.
نتجاوز القيمرية تستقبلنا روائح الأركيلة والدخان وبقايا الشاي والقهوة من مقهى النوفرة، يستقبلنا سوق القباقبية الذي كان أكثر غنى لأن الطريق كانت ضيقة، والبضاعة تتلاصق بين المحلات.. ونشيح وجوهنا عن واجهات الفضة والذهب التي لم تكن تعني لنا شيئاً، كل هذا قبل أن يصل مسك العطر وروائح الورود الدمشقية المقطرة الممزوجة بصوت الحمام الذي يملأ كل الأماكن..
والأعذب إن كان متماهياً مع وقت صلاة الظهر التي كنت أشعر أنها تصل دمشق كلها من الجامع الأموي.
كانت حُزم الكتب مربوطة بخيط ثخين "مصّيص" لا يسمح لك البائع أن تحل عقدته، وعليك أن تشتري على الأمانة وكان الجميع يبيعون بأمانة..
أما الذي يشدك أكثر أن كثيراً من الباعة كانوا طلاباً يبيعون كتبهم ويشترون كتب الصف الأعلى.. نشتري ونعود نحمل كتباً سترافقنا عاماً كاملاً، وقد ترافق غيرنا، وهي تحافظ على شكلها كما حافظت على العِلم الذي في بطونها.
٨. البحثُ عن بقايا من..
الذات
في اليوم التالي لإحضار الكتب، تبدأ عملية تحضير الملابس الخاصة بالمدارس.. وعمليات البحث عن أشيائنا المدرسية..
• نبحث عن بقايا ممحاة كنا نستعملها لنمحو أخطاءنا العلمية، أو ما لا نريد أن يقرأه إلا نحن ومن نحب أو من نسمح له القراءة..
• نبحث عن مبراة بدأ الصدأ يزحف إلى شفرتها التي بدأت تتثلم وتتآكل من كثرة البري والعمل..
• نبحث عن مِسطرة من خشب تعبت من كثرة الاستعمال، ومازالت آثار أيدينا عليها.. لكنها لم تمسح الأرقام عنها..
• نبحث عن بقايا أقلام الرصاص التي تركنا رؤوسها كما هي بعد كتابة آخر حرف في العام الذي انصرم..ونطمئن على الممحاة التي كانت في ذيله.. أما زالت طرية صالحة للمحو أم أنها جفت ويبست؟
• نبحث عن قلم الحبر "استيلو" الذي علمنا كيف نكتب، ونجري عملية فحص لقطعه، فقد تكون قطعة استهلكت فنستبدل بها جديدة..
• نبحث عن الدواة ألا يزال في قعرها بعض الحبر، ولولا الحياء لكنا زدنا على الحبر بعض الماء كما يفعل الحلاب الغشاش لتكفينا مؤونة العام للكتابة..
• نبحث عن بقايا دفاتر لا يزال فيها بعض الورق الصالح للكتابة، والشاطر من يلملم تلك الأوراق من الدفاتر ويعيد صناعة دفتر جديد.. تخيطه إبرة الأم بالقطب التي كانت أقوى من الخرزات الحديدية..
• ننزع التجليد الأزرق أو "البيج" عن دفاترنا القديمة وعن كتبنا التي رافقتنا عاماً كاملاً عساها تغطي أغلفة الكتب القديمة التي اشتريناها من المسكية، ولا يبقى من التكلفة إلا "الإتيكيت" التي سنكتب على سطرها الأول أسامينا وعلى الثاني اسم المادة ونترك الثالث لكتابة الصف والشعبة والرابع لاسم المدرسة.
وأحياناً لم نكن نغيرها بل نجري عليها تعديلاً بسيطاً في الصف والشعبة، فقد تكون المادة نفسها واسم المدرسة هو نفسه وأسماؤنا قد نغمقها.. نوعاً من الفخر والتباهي والغرور الذي يعبر عن نجاحنا.
٩. تحت العريشة.. سوا..
اقعدنا..
كان في بيتنا شجرة عنب فلا هي بالعريشة ولا هي بالجفنة، شجرة لأن جذرها في أرض "الديار" وجذعها يرتفع نحو سبعة أمتار فكان يعلو بيتنا وبيت الجيران الذين يسكنون فوقنا؛ خدمة الشجرة على سكان الغرف الأرضية وجناها للأعلى من الورق والعنب، ولكن كانت تصلنا حصة من الورق عندما يعلم الجيران أننا صنعنا الوجبة السحرية "التبولة" لكن لا يعود صحنهم فارغاً، ويصلنا شيء من العنب عند نضجه..الذي يكون حان عند عودتنا..
في خلال أيام قليلة تبدأ أوراق العريشة الصفراء تتساقط معلنة انتهاء الموسم وبداية فصل الخريف..
لم تكن السيدة فيروز قد غنت بعد أغنيتها الرائعة "ورقو الأصفر شهر أيلول" التي صارت ترتيلة للشهر لا يتجاوزها إنسان سمعها ولم تذكره بالخريف.. ولم تكن قد غنت أغنية "وجّك بيذكر بالخريف".. وإلا كنت غنيت معها الأغنيتين مع أغنيتها "تحت العريشة سوا اقعدنا"..
١٠. نحو المدرسة..
بداية يومٍ..
كان يومي المدرسي يتبع تقليداً رتيباً (روتينياً) يبدأ من غسل الوجه واليدين وارتداء الملابس، ثم الاتجاه نحو المطبخ المشترك أضع إبريق الشاي ثم أقصد فرن "أبو سليمان" وكنت زبوناً يومياً أشتري حاجة البيت من الخبز التي تنقص رغيفاً ساخناً التهمه وأنا في الطريق من الفرن إلى البيت علماً بأن المسافة قصيرة جداً بضعة أمتار مع الساحة..
أتناول الفطور الذي كان معتمداً في غالبية البيوت الدمشقية في ذاك الزمن..أحمل محفظتي وأتجه نحو المدرسة..
١١. مشوار الصباح..
عبق الأماكن..
يبدأ المشوار اليومي نحو المدرسة من ساحة باب توما ألتفت يميناً قليلاً يستقبلني الطريق الحجري.. وترحب بي على جانبي الطريق محلات تركت في الذاكرة حنيناً ولا تزال.. على يمين الطريق مسمكة بطبوطة مقابلها فرنان وبينهما السمكري وبياع الجرائد ثم مكتبة قازاريان التي لا تزال قائمة ومقابلها بقاليتان مشهورتان واحدة لبيت البزرة والثانية لبيت حلاوة.. ثم فرن أبو فارس ومحل دهان "أبو سامي سويد" الذي لا يزال ومحلات صغيرة أشهرها محل "أبو ماضي لبيع القرطاسية، ونلقي نظرة على ثانوية السابعة للبنات، وبائع الخضار الذي كانت رائحة الدراق عنده يعبق بها المكان، ومقابلهما عيادة الطبيب "حنين بيلونة" التي رأيت بابها مؤخراً مغلقاً بزردة صغيرة وكان من أشهر الأطباء في دمشق، ومن يعرفه يتذكر أن سيكارة الحمراء لم تفارق شفتيه لحظة وعاش مئة عام (ليس تشجيعاً على التدخين). وبعده بقليل على يميننا بناء كبير قيل إنه "سينما" ثم نشم رائحة الكاتو من محل ديروان، وندخل على اليسار في الحارة التي تعج بالطلاب من الجنسين، لكنهم يتفرقون بحسب المدرسة، البنات إلى مدرستَي المحبة الرسمية والخاصة، والصبيان إلى مدرسة المنصور الرسمية.
١٢. رَجعُ الحَنين..
لا أزالُ أعيشُه..
كان المشوار يبدأ السابعة إلا ربعاً مع صوت موسيقى البرنامج الأشهر في ذاك الزمان "مرحباً يا صباح" الوجبة الفيروزية الصباحية، الذي كان يرافقنا طوال الطريق من شبابيك البيوت العتيقة وأبوابها المفتوحة على الحب والجمال، لأن كل الذين استيقظوا يستمعون إليه.
كان الصوت يصلنا مع نكهة القهوة العابقة تحاول أن تنافس رائحة الياسمين المتعربش، والورد الدمشقي المتباهي بألوانه.
هذا المشوار الصباحي الذي كان بين البيت والمدرسة أعيشه كل فترة أعيد فيه ذكريات الطفولة، لكن ما يؤسف له أن عبق الماضي تلاشى، واضمحل، فلا رائحة سمك بطبوطة بقيت، ولا رائحة غليون قازاريان تفوح، لا رائحة الخبز نادتك، ولا صوت باعة الحليب وخضروات الغوطة وفاكهتها وصلك..كل هذا وغيره غاب من ستائر النسيان التي انسدلت على زمن حلو بكل ما فيه، نحاول رفعها، بأن نعاود السير على آثار أقدامنا التي لا تزال على الحجر العتيق المرصوف الذي كان كلما مررنا فوقه زادنا قوة..
البعث







